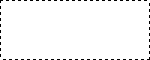بقلم م/ شوقي عقل
تعددت الرؤى في تفسير نشوء ظاهرة الإسلام السياسي، فبينما لجأ قطاع واسع من اليسار إلى الصيغ التقيمية الجاهزة للنظر إلى الظاهرة باعتبارها نتاج الفكر اليميني الرجعي لتحويل أنظار الجماهير العريضة الفقيرة عن بؤسها، واستبدال حلمها بالتغيير والاشتراكية بعالم جميل موعود في العالم الآخر، ومن ثم دفعها للصدام مع قوى التقدم تحت دعاوى الكفر والإلحاد. وهو وإن كان تحليلا يحمل جزءً من الصدق ولكنه غير كاف لتفسير القدرة الهائلة لتلك الظاهرة على الإنتشار والتأثير في قطاعات واسعة من الجماهير. وعلى العكس نظر جزء آخر من مثقفي اليسار إلى الظاهرة باعتبارها تعبير عن ثقافة (ايدلوجيا) شعبية قد تؤدي إلى الوصول بأفراد من عامة الشعب إلى السلطة، وهو ما حدث بالفعل، غير أنه أثمر في واقع الأمر نظاما معاديا للفقراء وللشعب كما نرى الآن.
يعزل الليبراليون نشوء ظاهرة الإسلام عن أصولها الاجتماعية والطبقية، ويتم التركيز على عامل الثقافة المرجعية باعتبارها عاملا وحيدا مسببا لنشأة الظاهرة، بعد عزلها المتعمد عن حركة الواقع بعناصره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
تعود بدايات نشوء ظاهرة الإسلام السياسي في العالم إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي، وفي مصر يقرر البعض من الباحثين أن للسادات اليد الطولى في نشأة تلك الظاهرة حين قام (محمد عثمان)، حليفه في انقلابه المعروف بثورة التصحيح، بدعم وتكوين المجموعات السلفية داخل الجامعات للقضاء على قوة اليسار المناهض لتوجهاته السياسية والإجتماعية، تختزل تلك النظرة الضيقة نشأة تيار الإسلام السياسي في قرار أمني، ولاتتناسب مع حجم الظاهرة وانتشارها وتأثيرها، ليس في مصر وحدها، بل وفي باكستان وأفغانستان والأردن والجزائر وتونس وسوريا وفلسطين (غزة) واليمن والصومال ودول الخليج وإيران التي قام فيها أول نظام حكم اسلامي في التاريخ الحديث بعد إنهيار نظام الخلافة العثماني.
كنت في حقبة التسعينيات وأنا اتصفح الجرائد القومية التي تعلن بالبنط العريض عن مصرع (أمير) من امراء الجماعات السلفية، أرى في ذلك الأمير شابا صغير السن لا يتجاوز العشرين من عمره يحمل سلاحا ويخرج في مهمة (جهادية) ضد نظام الدولة الحاكم، كان التساؤل الذي يلح علي دوما: ماذا وراء تلك العباءة الدينية؟ ما هي البيئة التي أنتجت كل هذا العنف الذي لا يمكن تفسيره بمجرد تأثير شيوخ السلفية، فهم دوما هناك، تجدهم أينما وجد الفقر والتخلف والقهر. أين القوة المحركة في مجمل العلاقات الاجتماعية والسياسية وراء خروج هذا (الأمير!) اليافع الذي لا تتجاوز معلوماته في الدين المعلومات المدرسية لشاب في مثل عمره؟؟
هناك كما اسلفت تفسيرات عدة لنشوء ظاهرة الإسلام السياسي، تشكل معا رؤية شاملة للظاهرة لا تقتصر على التحليلات اليسارية الإقتصادية، أو السذاجة الليبرالية لمثقفي الفضائيات، ولا تقتصر على الركض وراء كل شكل من أشكال الرفض باعتباره إرهاصة بثورة، ولا تقتصر على تأثير عامل دون حساب بقية العوامل، كما يحدث في بعض التحليلات اليسارية التي قررت عامل وحيد مؤثر في إجمالي الحراك الإجتماعي في مصر وهو العامل الخارجي المتمثل في هيمنة الإستعمار العالمي. تداخل العوامل المنشأة للظاهرة في مصر وتعددها يرتبط بالطبيعة الإجتماعية و السياسية والإقتصادية لنظام ترك قياده لعديد من القوى الخارجية والداخلية وكان الفساد هو سمته الأساسية، وعمل على تدمير البنى الإقتصادية والسياسية والإجتماعية لمكونات المجتمع، كانت العوامل الخارجية شديدة التأثير بأشكال مباشرة وغير مباشرة مما أنتج في النهاية العديد من أنماط علاقات الإنتاج منها ما هو شديد التخلف ( مازال نظام المقايضة قائم في بعض الأماكن في المحروسة!) ومنها ما هو متقدم باعتبار أشكال علاقات وأدوات الانتاج، وذلك طبقا لمقاييس عالم السوق، هذه الأنماط المتعددة المتباينة لعلاقات الإنتاج أنتجت معها رؤى إجتماعية وسياسية شديدة التباين، تمهيدا للحظة يصبح فيها الواقع السياسي والمرجعي شديد الإختلاف والتعدد بما يعني سيولة الواقع وجموده عند لحظة تعادل القوى دون قدرة اي منها على الحسم، لعل ذلك يفسر الوضع القائم الآن في المحروسة، ولعل ذلك يفسر أيضا سر تأييد الولايات المتحدة للإخوان!
فيما يلي سأقدم الرؤى المختلفة لأسباب نشوء ظاهرة الإسلام السياسي.
1- هزيمه المشروع الوطني للتحرر من الإستعمار وللتنمية ولبناء صناعة وطنية الذي يعد التعبير القوي عن طموح شريحة من البرجوازية المصرية للتخلص من التبعية للإستعمار، والذي ناضلت مصر من أجله طويلا ومن خلال محطات كبرى بدأت بثورة عرابي 1882 وثورة 1919 ونضال الشعب المستمر بدون توقف ضد القصر والاحتلال عبر زمن امتد من 1919 حتى 1952، حين جاء عبدالناصر وسعى للتحرر وإجلاء الاحتلال والتصنيع. استطاع برنامجه الوطني أن يستقطب شرائح واسعة من الطبقة البرجوازية الصغيرة والعمال وفقراء الفلاحين في المدن والريف لهذا المشروع، حتى هزيمة مشروعه في نكسة يونيو، كانت هذه الهزيمة بمثابة سلب لحلم جماهير عريضة وجدت نفسها بعد وفاة عبد الناصر يتيمة عارية من أية روئ مستقبلية لحل مشاكلها، فبكت حلمه وانكفأت إلى عالم الأحلام بحثا عن بديل، ونشأ فراغ كبيربعد هزيمة المشروع الناصري. يذكر الجبرتي أن المصريين كانوا دائما يلجأون للدين كلما آلمت بهم نازلة، كان هناك دائما الشيوخ والملتحون ومن وصفهم الجبرتي (بحملَة النبابيت) مستعدون دائما ليقدموا عقب كل هزيمة كبرى للأمة، حلا جاهزا بالعودة إلى الإيمان الحق وليفسروا كل هزيمة بأنها بسبب البعد عن الله. وفي عصرنا قال كبيرهم أنه صلى لله شكرا وامتنانا بعد هزيمة مصر في حرب 1967.
ملأ تيار الاسلام السياسي الفراغ الذي تركه هزيمة المشروع الناصري.
2- من ناحية أخرى فإن هذه الهزيمة شكلت إذلالاً للحس الوطني ومست الإعتزاز العالي للروح الوطنية المصرية، وكان الوجدان الشعبي الفخور بحاجة للتعويض، قدم تيار الإسلام السياسي من خلال تجسيده واستدعاءه لأمجاد ماضية هذا البديل. استمد من الماضي البعيد حين سادت المنطقة دول الخلافة الراشدة ثم العباسية والأموية، وحتى من الدولة العثمانية، بعد تضخيم الصور وقولبتها لملائمة الاحتياج. الإعتزاز والفخر بالماضي المجيد للوقوف أمام هزيمة حضارية وسياسية وثقافية مثلها الغرب المتقدم بإنجازته العلمية وتفوقه الساحق في كل المجالات، كان اللجوء إلى الماضي وبث الحياة فيه ومحاولة استعادته لخلق التوازن ومواجهة الإنكسار، وهو ما يفسر القبول العام لظهور أنصاف المثقفين على صفحات الجرائد القومية، باعتبارهم علماء يملأون الدنيا ضجيجا عن إنجازات الحضارة العربية والاسلامية بتجاهل متعمد لواقع مزري حالي. لقى أمثال هؤلاء إلتفافا واسعا للباحثين عن انتصارات وفخار حتى ولو كان شكليا للحفاظ على هويتهم وتماسكهم امام هجمة الإستعمار العالمي الكاسحة، ولقت مرجعيتهم الدينية السلفية قبولا باعتبارها المرجعية الحافظة للتماسك وتأكيد الذات الوطنية.
3- في كتابه الشهير "جهاد ضد عالم ماك" يرى المفكر الامريكي "بنجامين باربر" أن هناك تلازما بين نشوء ظاهرة النزعات الأصولية بكافة أشكالها (مسيحية – مسلمة –بوذية- هندوسية- عرقية- طائفية- قومية) وبين انتصار قيم السوق فيما عرف بالعولمة، وهو ينسب معسكر الرأسمالية العالمية إلى "محلات ماكدونالدز" باعتبارها رمزا دالا عليها. يفسر الكاتب هذا التلازم في مقولة أساسية هي أن قوى السوق (الاستعمار الجديد- النيوليبرالية) تسعى لتدمير الحدود القومية للدول، إنها تسعى لجعل العالم وحدة واحدة تخضع لسيطرتها، إنها تريد إنتقالا سريعا للأموال والبضائع عبر حدود الدول السياسية والمادية، دمرت وتدمر في سعيها هذا العديد من الدول ( يوغسلافيا – العراق - الاتحاد السوفييتي – السودان - سوريا الآن) في ذلك المسعى يلتقي معها الفكر الأصولي الذي يسعى هو أيضا لتدمير مؤسسات الدولة لصالح الدين او الطائفة أو العشيرة أو العرق، إنهما قوتان متلازمتان لهما نفس الهدف رغم تباينهما وصراعهما الظاهري.
لعل ذلك يفسر أن نشوء ظاهرة العنف الأصولي في العالم ومنها مصر تزامن مع ظهور ماسمي بالليبرالية الجديدة على يد كل من مارجريت تاتشر في المملكة المتحدة ورونالد ريجان في الولايات المتحدة في بداية السبعينيات، ظهر هذا مع ذاك واستمرا في النمو المتلازم، حيثما تجد هذا فلابد ان تجد الآخر، لم تكن مصر بمعزل عن هذا التغيير، بل كانت في القلب منه! ليست مصادفة أن يشكل المصريين نسبة كبيرة من مجاهدي افغانستان، والبوسنة، وأن يكون محمد عطا المصري الجنسية، القائد المخطط لعملية تدمير برج التجارة العالمي.
تعددت الرؤى في تفسير نشوء ظاهرة الإسلام السياسي، فبينما لجأ قطاع واسع من اليسار إلى الصيغ التقيمية الجاهزة للنظر إلى الظاهرة باعتبارها نتاج الفكر اليميني الرجعي لتحويل أنظار الجماهير العريضة الفقيرة عن بؤسها، واستبدال حلمها بالتغيير والاشتراكية بعالم جميل موعود في العالم الآخر، ومن ثم دفعها للصدام مع قوى التقدم تحت دعاوى الكفر والإلحاد. وهو وإن كان تحليلا يحمل جزءً من الصدق ولكنه غير كاف لتفسير القدرة الهائلة لتلك الظاهرة على الإنتشار والتأثير في قطاعات واسعة من الجماهير. وعلى العكس نظر جزء آخر من مثقفي اليسار إلى الظاهرة باعتبارها تعبير عن ثقافة (ايدلوجيا) شعبية قد تؤدي إلى الوصول بأفراد من عامة الشعب إلى السلطة، وهو ما حدث بالفعل، غير أنه أثمر في واقع الأمر نظاما معاديا للفقراء وللشعب كما نرى الآن.
يعزل الليبراليون نشوء ظاهرة الإسلام عن أصولها الاجتماعية والطبقية، ويتم التركيز على عامل الثقافة المرجعية باعتبارها عاملا وحيدا مسببا لنشأة الظاهرة، بعد عزلها المتعمد عن حركة الواقع بعناصره الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
تعود بدايات نشوء ظاهرة الإسلام السياسي في العالم إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي، وفي مصر يقرر البعض من الباحثين أن للسادات اليد الطولى في نشأة تلك الظاهرة حين قام (محمد عثمان)، حليفه في انقلابه المعروف بثورة التصحيح، بدعم وتكوين المجموعات السلفية داخل الجامعات للقضاء على قوة اليسار المناهض لتوجهاته السياسية والإجتماعية، تختزل تلك النظرة الضيقة نشأة تيار الإسلام السياسي في قرار أمني، ولاتتناسب مع حجم الظاهرة وانتشارها وتأثيرها، ليس في مصر وحدها، بل وفي باكستان وأفغانستان والأردن والجزائر وتونس وسوريا وفلسطين (غزة) واليمن والصومال ودول الخليج وإيران التي قام فيها أول نظام حكم اسلامي في التاريخ الحديث بعد إنهيار نظام الخلافة العثماني.
كنت في حقبة التسعينيات وأنا اتصفح الجرائد القومية التي تعلن بالبنط العريض عن مصرع (أمير) من امراء الجماعات السلفية، أرى في ذلك الأمير شابا صغير السن لا يتجاوز العشرين من عمره يحمل سلاحا ويخرج في مهمة (جهادية) ضد نظام الدولة الحاكم، كان التساؤل الذي يلح علي دوما: ماذا وراء تلك العباءة الدينية؟ ما هي البيئة التي أنتجت كل هذا العنف الذي لا يمكن تفسيره بمجرد تأثير شيوخ السلفية، فهم دوما هناك، تجدهم أينما وجد الفقر والتخلف والقهر. أين القوة المحركة في مجمل العلاقات الاجتماعية والسياسية وراء خروج هذا (الأمير!) اليافع الذي لا تتجاوز معلوماته في الدين المعلومات المدرسية لشاب في مثل عمره؟؟
هناك كما اسلفت تفسيرات عدة لنشوء ظاهرة الإسلام السياسي، تشكل معا رؤية شاملة للظاهرة لا تقتصر على التحليلات اليسارية الإقتصادية، أو السذاجة الليبرالية لمثقفي الفضائيات، ولا تقتصر على الركض وراء كل شكل من أشكال الرفض باعتباره إرهاصة بثورة، ولا تقتصر على تأثير عامل دون حساب بقية العوامل، كما يحدث في بعض التحليلات اليسارية التي قررت عامل وحيد مؤثر في إجمالي الحراك الإجتماعي في مصر وهو العامل الخارجي المتمثل في هيمنة الإستعمار العالمي. تداخل العوامل المنشأة للظاهرة في مصر وتعددها يرتبط بالطبيعة الإجتماعية و السياسية والإقتصادية لنظام ترك قياده لعديد من القوى الخارجية والداخلية وكان الفساد هو سمته الأساسية، وعمل على تدمير البنى الإقتصادية والسياسية والإجتماعية لمكونات المجتمع، كانت العوامل الخارجية شديدة التأثير بأشكال مباشرة وغير مباشرة مما أنتج في النهاية العديد من أنماط علاقات الإنتاج منها ما هو شديد التخلف ( مازال نظام المقايضة قائم في بعض الأماكن في المحروسة!) ومنها ما هو متقدم باعتبار أشكال علاقات وأدوات الانتاج، وذلك طبقا لمقاييس عالم السوق، هذه الأنماط المتعددة المتباينة لعلاقات الإنتاج أنتجت معها رؤى إجتماعية وسياسية شديدة التباين، تمهيدا للحظة يصبح فيها الواقع السياسي والمرجعي شديد الإختلاف والتعدد بما يعني سيولة الواقع وجموده عند لحظة تعادل القوى دون قدرة اي منها على الحسم، لعل ذلك يفسر الوضع القائم الآن في المحروسة، ولعل ذلك يفسر أيضا سر تأييد الولايات المتحدة للإخوان!
فيما يلي سأقدم الرؤى المختلفة لأسباب نشوء ظاهرة الإسلام السياسي.
1- هزيمه المشروع الوطني للتحرر من الإستعمار وللتنمية ولبناء صناعة وطنية الذي يعد التعبير القوي عن طموح شريحة من البرجوازية المصرية للتخلص من التبعية للإستعمار، والذي ناضلت مصر من أجله طويلا ومن خلال محطات كبرى بدأت بثورة عرابي 1882 وثورة 1919 ونضال الشعب المستمر بدون توقف ضد القصر والاحتلال عبر زمن امتد من 1919 حتى 1952، حين جاء عبدالناصر وسعى للتحرر وإجلاء الاحتلال والتصنيع. استطاع برنامجه الوطني أن يستقطب شرائح واسعة من الطبقة البرجوازية الصغيرة والعمال وفقراء الفلاحين في المدن والريف لهذا المشروع، حتى هزيمة مشروعه في نكسة يونيو، كانت هذه الهزيمة بمثابة سلب لحلم جماهير عريضة وجدت نفسها بعد وفاة عبد الناصر يتيمة عارية من أية روئ مستقبلية لحل مشاكلها، فبكت حلمه وانكفأت إلى عالم الأحلام بحثا عن بديل، ونشأ فراغ كبيربعد هزيمة المشروع الناصري. يذكر الجبرتي أن المصريين كانوا دائما يلجأون للدين كلما آلمت بهم نازلة، كان هناك دائما الشيوخ والملتحون ومن وصفهم الجبرتي (بحملَة النبابيت) مستعدون دائما ليقدموا عقب كل هزيمة كبرى للأمة، حلا جاهزا بالعودة إلى الإيمان الحق وليفسروا كل هزيمة بأنها بسبب البعد عن الله. وفي عصرنا قال كبيرهم أنه صلى لله شكرا وامتنانا بعد هزيمة مصر في حرب 1967.
ملأ تيار الاسلام السياسي الفراغ الذي تركه هزيمة المشروع الناصري.
2- من ناحية أخرى فإن هذه الهزيمة شكلت إذلالاً للحس الوطني ومست الإعتزاز العالي للروح الوطنية المصرية، وكان الوجدان الشعبي الفخور بحاجة للتعويض، قدم تيار الإسلام السياسي من خلال تجسيده واستدعاءه لأمجاد ماضية هذا البديل. استمد من الماضي البعيد حين سادت المنطقة دول الخلافة الراشدة ثم العباسية والأموية، وحتى من الدولة العثمانية، بعد تضخيم الصور وقولبتها لملائمة الاحتياج. الإعتزاز والفخر بالماضي المجيد للوقوف أمام هزيمة حضارية وسياسية وثقافية مثلها الغرب المتقدم بإنجازته العلمية وتفوقه الساحق في كل المجالات، كان اللجوء إلى الماضي وبث الحياة فيه ومحاولة استعادته لخلق التوازن ومواجهة الإنكسار، وهو ما يفسر القبول العام لظهور أنصاف المثقفين على صفحات الجرائد القومية، باعتبارهم علماء يملأون الدنيا ضجيجا عن إنجازات الحضارة العربية والاسلامية بتجاهل متعمد لواقع مزري حالي. لقى أمثال هؤلاء إلتفافا واسعا للباحثين عن انتصارات وفخار حتى ولو كان شكليا للحفاظ على هويتهم وتماسكهم امام هجمة الإستعمار العالمي الكاسحة، ولقت مرجعيتهم الدينية السلفية قبولا باعتبارها المرجعية الحافظة للتماسك وتأكيد الذات الوطنية.
3- في كتابه الشهير "جهاد ضد عالم ماك" يرى المفكر الامريكي "بنجامين باربر" أن هناك تلازما بين نشوء ظاهرة النزعات الأصولية بكافة أشكالها (مسيحية – مسلمة –بوذية- هندوسية- عرقية- طائفية- قومية) وبين انتصار قيم السوق فيما عرف بالعولمة، وهو ينسب معسكر الرأسمالية العالمية إلى "محلات ماكدونالدز" باعتبارها رمزا دالا عليها. يفسر الكاتب هذا التلازم في مقولة أساسية هي أن قوى السوق (الاستعمار الجديد- النيوليبرالية) تسعى لتدمير الحدود القومية للدول، إنها تسعى لجعل العالم وحدة واحدة تخضع لسيطرتها، إنها تريد إنتقالا سريعا للأموال والبضائع عبر حدود الدول السياسية والمادية، دمرت وتدمر في سعيها هذا العديد من الدول ( يوغسلافيا – العراق - الاتحاد السوفييتي – السودان - سوريا الآن) في ذلك المسعى يلتقي معها الفكر الأصولي الذي يسعى هو أيضا لتدمير مؤسسات الدولة لصالح الدين او الطائفة أو العشيرة أو العرق، إنهما قوتان متلازمتان لهما نفس الهدف رغم تباينهما وصراعهما الظاهري.
لعل ذلك يفسر أن نشوء ظاهرة العنف الأصولي في العالم ومنها مصر تزامن مع ظهور ماسمي بالليبرالية الجديدة على يد كل من مارجريت تاتشر في المملكة المتحدة ورونالد ريجان في الولايات المتحدة في بداية السبعينيات، ظهر هذا مع ذاك واستمرا في النمو المتلازم، حيثما تجد هذا فلابد ان تجد الآخر، لم تكن مصر بمعزل عن هذا التغيير، بل كانت في القلب منه! ليست مصادفة أن يشكل المصريين نسبة كبيرة من مجاهدي افغانستان، والبوسنة، وأن يكون محمد عطا المصري الجنسية، القائد المخطط لعملية تدمير برج التجارة العالمي.